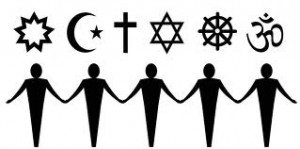
أ.د/ طه جابر العلواني.
منذ أن عرف الإنسان الأديان؛ بدأت فصائله تتمايز، فهذا له دين، وآخر لا دين له، وثالث يتدين بدين وضعي، وضعه البشر أنفسهم، ورابع يتدين بدين سماوي، نزلت به ملائكة من السماء على رسل من الأرض، وهذا يتخذ لله أبناء، وبنات، ويشبهه بخلقه، وذاك ينزهه، وذاك يجعل الملائكة إناثًا، ويعتبرها بنات لله (جل شأنه)، وهؤلاء يتخذون أصنامًا آلهة، ويضيفونها إلى الله (جل شأنه)، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا..، وذاك.. إلخ.
وتحارب أهل الأديان، وتقاتلوا فيما بينهم، من بعد ما جاءتهم البينات، واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم؛ بغيا، وحسدا، واستعلاء على سواهم؛ فكل من اعتنق دينًا، جعله –وحده- الحق، الذي لا مراء فيه، ولا شك، ولا اختلاف، واعتبر دين غيره باطلا؛ ليس بينه، وبين الحق صلة، أو وشيجة.
وقد أقلقت هذه الظاهرة مضاجع كثير من رجال الدين، الذين ينظرون إلى الدين على أنه وسيلة توحيد للبشر، وجمع لكلمتهم، ومنهج لإحلال السلام فيما بينهم، فما الذي حدث لكي يكون الدين هو منبع السلام، والعدل، والحرية، وسائر القيم؟ وهو نفسه؛ منبع للتحارب، والتقاتل، والاختلاف.
وبدأ هؤلاء، ومعهم عديد من الفلاسفة؛ يحاولون معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وهل هي ظاهرة لصيقة بالدين، لا تنفك عنه، أم هي ظاهرة طارئة، أتت من خارج الدين، والدين منها براء؟. وخرجوا بتفسيرات عديدة، وجاءوا بإجراءآت كثيرة، وحاول كثيرون منهم، إعادة تفسير الدين بطريقة تجعله كما كان في البداية؛ وسيلة لإحلال السلام بين البشر.
ومما يستدعيه الجدل في هذه الظاهرة، قضية: ابني آدم ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ* لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ* إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ* فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ *مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ (المائدة 32:27)، فالمثل الذي ضربه الله لابني آدم مثل فيه دروس كثيرة في هذا المجال؛ فهو يصور لنا كيف قلبت النفس البشرية المنحرفة، العبادة الخالصة لوجه الله، التي يفترض أن يتقرب الناس بها إلى الله (جلَّ شأنه)، وحولتها إلى وسيلة للصراع، ودافع من دوافع القتل؛ فيقتل بريء لا ذنب له إلا لصلاحه، ومحبته لله، وقبول الله لقربانه، لمجرد أنَّ الله قد تقبل منه، ولم يتقبل من الآخر. فالدين بحد ذاته ليس مصدرًا للاختلاف، والتناقض، والعداوات؛ لكن استعدادات النفس البشرية المختلفة، إذالم يعرف الإنسان كيف يسيطر عليها، ويحسن توجيهها، فإنَّها قد تؤدي به إلى الانحراف في كل شئ حتي في العبادة، وكذلك يقول الله (جل شأنه) ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (البقرة:253) ، ويقول في الآية الأخرى ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (البقرة:213) فهذه الآية صريحة؛ بأنَّ الناس كانوا أمَّة واحدة، واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، التي كان يفترض أن تعزز من وحدتهم؛ لما فيها من توافق كبير بين فطرهم، وبين ما جاءهم من الحق في الأديان؛ لكن نزوع بعض البشر إلى البغي، وتجاوز الحدود، والاستعلاء على الآخرين، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، وإسرافهم في الموارد، والاستبداد بها؛ الذي يقودهم بعد ذلك إلى البغي، والإسراف في الاعتداء، والقتل، وما إليه؛ أدى بهم إلى الاختلاف، ويقول (جل شأنه) ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ*إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (هود:119)، أي، وللرحمة خلقهم، وليس للاختلاف كما ذكر كثير من المفسرين؛ لأنَّ الاختلاف نجم عن: بغي البشر بعضهم على بعض، وحسد، ورغبة بعضهم؛ للاستعلاء على البعض الآخر، واستغلالهم، والاستبداد بشأنهم.
إذن، فالدين ليس مصدرًا للشقاق، ولا منبعًا للإرهاب، والاختلاف؛ بل هو منبع، لكل خير، لكنَّها النفس الإنسانيَّة، القابلة للاستقامة عليه، أو الانحراف به، وهي التي تنحرف به عن مساره، وتخرجه عن أهدافه، وتجعله منبعًا للشقاق، وللاختلاف، والصراع، والتقاتل، والتحارب، وهذا الإسراف؛ يتخذ أشكالًا كثيرة، والحسد، والبغي من الإنسان يتخذ صورًا عديدة في التاريخ، وفي الحاضر، وفي المستقبل. واتهام الدين بأنَّه سبب الاختلاف؛ لأنَّه يميز بين أهل الخير، وأهل الشر، ولا يجعلهم سواء؛ فيمارس أهل الشر الشر كله، دون أن يستطيع غيرهم أن يميز بينهم، وبين أهل الخير. إن بعض الناس نتيجة للنظرة الخاطئة؛ اختاروا أن يرفضوا الأديان كلها، ويلجأوا إلى الإلحاد، ظنًا منهم أنَّ الإلحاد سيساعدهم على تجفيف منابع الصراع، وكان ذلك ضلالًا كبيرًا، وفساد أدى إلى إبادة أمم، وشعوب كثيرة بسيف الإلحاد، وذهب البعض إلى أنَّ التحكم بالأديان، وإعادة بناءها؛ بناءً، بشريًّا، وضعيًّا، هو الحل، فألَّهوا أنفسهم؛ وأصبحوا يشرعون للناس من منطلقات: الإسراف، والبغي، والحسد؛ تشريعات هي أقرب إلى تشريع: ابن آدم القاتل، وذهب بعضهم إلى ضرورة استبدال الأديان كلها، أو بعضها، والأخذ منها بشكل انتقائي؛ يتحكمون هم فيه، فيكونون، كمن اتخذ إلهه؛ هواه، وأضله الله؛ على علم، ولم يخل زمن، أو شعب من أفراد؛ قدموا بعض التصورات نحو ما اعتبروه: ظاهرة مُسلَّمة؛ ألا وهي: ظاهرة الاختلاف في الدين؛ باعتباره منبعًا من منابع الاختلاف، والنزاع، والصراع بين البشر. والمسلمون أنفسهم؛ قد ظهر فيهم من يذهبون ذلك المذهب، وينزعون إلى تحييد الأديان، وفي مقدمة هؤلاء ‹‹محي الدين بن العربي›› صاحب الفتوحات المكيَّة، وفصوص الحكم، وما إليها حيث نسب إليه قوله:
لقد كنتُ قبلَ اليوم أنكِرُ صاحبي…………………. إذا لم يكنْ ديني إلى دينِه داني
لقد صار قلبي قابلاً كلّ صورةٍ…………………… فمرعى لغزلان، وديرٌ لرهبان
وبيتٌ لأوثان، وكعبةُ طائفٍ ………………………وألواح توراة، ومصحفُ قرآنِ
أدين بدين الحبِّ أنّى توجّهــت ركائبه ……….. فالحبُّ ديني وإيماني
فإذن، دعوة توحيد الأديان، ومحاولة نزع فتيل الصراع بين البشر بذلك؛ دعوة قديمة، لجأ إليها الكثيرون، وجرى تبنيها، بأشكال مختلفة. والحق أنَّ الدين واحد، وهو أشبه بمقرر دراسي، متكامل، موضوع؛ ليشمل حياة الإنسان كلها، من رياض الأطفال، حتى ما بعد الدكتوراه؛ جاء به الأنبياء على حلقات؛ فالعقيدة واحدة لدى الأنبياء كافَّة؛ فكلهم جاء يدعون إلى: توحيد الألوهيَّة، وتزكية النفس الإنسانيَّة، وإعمار الأرض. لكن الطرق، والوسائل قد تختلف، من عصر، إلى عصر، ومن قطر لآخر. فأبو الأنبياء كافَّة هو: ‹‹إبراهيم الخليل›› (عليه الصلاة والسلام)؛ جاء بالحنيفيَّة، وهي: تلك الأسس، والقيم العليا، التي لا تختلف الأديان فيها. وهي ما ذكرنا من: توحيد، وتزكية، وعمران؛ توحيد لله، وتزكية للإنسان، وعمران للأرض، وخاتم الرسل: ‹‹محمد›› (صلى الله عليه، وآله، وسلم)، وهو مثل: ‹‹موسى››، و‹‹عيسى›› (عليهما الصلاة، والسلام)، من ذرية إبراهيم كذلك. وكلهم من ذرية من حمل الله (جلَّ شأنه)، مع ‹‹نوح›› (عليه الصلاة، والسلام)؛ جاء بالقيم نفسها؛ ولذلك أكَّد القرآن الكريم على ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران:84). ولذلك اعتبر الإسلام مشتقًا من اسم مشترك بين الجميع؛ فلم يخاطب به بني إسرائيل، ولا بنو يعرب؛ بل خاطب به الناس كافَّه؛ لأنَّه: مأخوذ من إسلام الإنسان: وجهه لله تعالى، وهو معنى قيمي، لا يتوقف على: أي انتماء زائد على الانتماء للإنسانيَّة. أمَّا اليهوديَّة؛ فمنسوبة إلى بني إسرائيل، والنصرانيَّة؛ منسوبة إلى الحواريين: أنصار الله؛ فنحن في حاجة إلى أن نجمع أصحاب الأديان كلها، على الملة الأساسيَّة التي قامت عليها ملة ‹‹إبراهيم››؛ وهي : التوحيد، والتزكية، والعمران، وما تفرع عنها من قيم ثابتة؛ كالحريَّة، والعدالة، والمساواة، والتقوى؛ فإذا اتفقت كلمة البشر على هذا، وعادوا إلى ملة ‹‹إبراهيم›› في الدين، وإلى الأصل الآدمي في الانتماء، “كلكم لآدم، وآدم من تراب”، فلن يكونوا في حاجه بعد ذلك إلى البحث عن تلك الوسائل التي لم تنجح فيما مضي، ولن تنجح في الوقت الحاضر ولا يتوقع لها النجاح في المستقبل.
والله الموفق.
