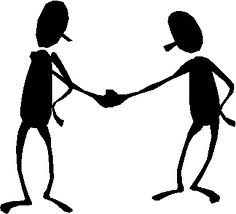
د. طه العلواني
لقد كثر في الآونة الأخيرة استعمال مفهوم “الآخر”، كأن يقال نحن والآخر، موقفنا من الآخر، دون أن يجري تحديدٌ لهذا الآخر. وفي البداية كان المتبادر إلى الذهن من قولهم “نحن والآخر” الآخر دينيًا؛ أي صاحب دين آخر، أو قوميًا، أو عرقيًا، أو جغرافيًا، أو ملاحظة للتصنيفات الاقتصادية كتصنيف العالم الأول، والعالم الثاني، والعالم الثالث، أو النامي، إلى غير ذلك. ثم توسع بعضٌ بهذا المفهوم ليجعلوا من الآخر كل من خالفك وكل مخالف لك في شأن من الشؤون أو أمر من الأمور فهو آخر بالنسبة لك وهذا تجاوز وإسراف في استخدام المفهوم أو المصطلح في ما وضع له. نجم هذا عن عدم التحديد بادئ ذي بدء تحديد المعنى المطلوب لهذا المصطلح منذ البداية فكانت النتيجة هذا الإسراف الذي نراه في التجاوز في استعمال هذا المفهوم.
وليفهم الآخر لا بد من فهم “نحن” وسؤال “من نحن؟” سؤال كان يطرح في المحيط الإسلامي في بداية الخمسينيات. وظل يطرح بإلحاح وكل فصيلة من فصائل الأمة كان يجيب عليه بطريقته وبأسلوبه الخاص، وذلك حينما حدث نوع من الاضطراب في تحديد مفهوم الهوية ومقاومات ومكونات تلك الهوية.
و“الآخر” مصطلح ولد في البيئة الغربية لا جذور له في البيئة المسلمة ففي البيئة الغربية وإبان الثورة الفرنسية كان يطلق على الثوار والمتبنين لمبادئ الثورة والمنادين بها من الأسماء ما يوحي بأنهم فريق واحد في مواجهة الاستبداد وفي مواجهة الإقطاع والرجعية وأعداء الحرية والمساواة والعدالة. وظل هذا المفهوم ينمو وينتشر في البيئة الغربية حتى انتقل إلى الثورة الأمريكية، فالثوار الأمريكان الذين كانوا يناضلون من أجل تحرير أنفسهم من هيمنة بريطانيا وفرنسا كانوا كثيرًا ما يشيرون إلى نحن We People والآخر The Other أولئك المستعمرين أولئك الذين جاءوا إلى أرض ليس لهم حق السيطرة عليها ولا الاستبداد بمقدراتها.
وظل أيضًا هذا المفهوم متداولاً إلى أن اتحدت الولايات الثلاثة عشر في فيلادلفيا ووضعت نواة وحدتها وحدة الولايات المتحدة فكانت We People مقابل The Others.
إذن هو مصطلح أو مفهوم مستورد ومورد إلى الساحة الفكرية واللغوية الإسلامية، لم يولد من رحم الثقافة الإسلامية ولم يتولد عن فكر إسلامي لأسباب سنأتي إلى بيانها تفصيلاً. الإسلام منذ بدايته نظر إلى (نحن) على أنه مصطلح يتناول البشرية كلها فالناس نحن، والعالم نحن، والبشر نحن، فكل بني آدم وكل المنتمين إلى هذه الأسرة الممتدة الأسرة البشرية يندرجون تحت مفهوم أو مصطلح (نحن)، والآخر لم إلا الشيطان. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (فاطر: 6) فإذا كان هناك من يستحق لفظ الآخر أو مفهوم الآخر أو أن يطلق عليه مصطلح الآخر فإنما هو الشيطان بالنسبة للتصور الإسلامي وللفكر الإسلامي.
ولقائل أن يقول هنا إذن فلماذا صنف الإسلام الناس إلى مؤمنين مسلمين، وكافرين مشركين، وكتابيين وغيرهم، ومنافقين؟ وهذه التصنيفات الثلاث نجد مثلها أيضًا في الداخل الإسلامي ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (فاطر: 32) فأيضًا هناك أصناف ثلاثة فما المانع من أن يطلق كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة على نفسه نحن ويطلق على غيره الآخر؟
الجواب: إن هذه التقسيمات سواء التقسيمات التي نجمت عن اختلاف ألسنتكم وألوانكم ليكون هذا الاختلاف وسيلة لتعارفكم وتآلفكم وتعاونكم والدخول في دائرة نحن أو أن الاختلاف هذا أو بيان هذا الاختلاف إنما هو تصنيف مؤقت يستخدم في حالة مؤقتة للإشارة إلى مواقف وأعمال ترفض وتقبل. وبالتالي فالتصنيف بحسب الأعمال لا يجعل من الإنسان آخر؛ ولكن يجعل من عمله شيئًا يمكن أن يوصف بالصلاح ويمكن أن يوصف بالفساد وما إليه وبالتالي فهذا التصنيف لا يمكن أن يوجد ما يمكن اعتباره أساسًا لمفهوم الآخر. وإذا اختلف الناس إلى فرق وطوائف وأحزاب فذلك لن يجعل من الفرقة أي فرقة نحن ويجعل من الفرق الأخرى آخر أو The Others وإذا كانت بعض الفرق الإسلامية والطوائف قد غلت في مذهبيتها وطائفيتها نتيجة ظروف مختلفة وأدبيات متنوعة وثقافات تحتاج إلى مراجعة مثل ثقافة الفرقة النّاجية والفرق الهلكى وما إلى ذلك فذلك لا يمثل أساسًا أو منطلقًا أو دليلاً أو أصلاً من أصول الإسلام يسمح بهذا. فاختلاف المذهب واختلاف الطائفة واختلاف الدين واختلاف اللون واختلاف الفكر واختلاف التصور واختلاف ممارسة الحياة والمستوى المعاشي كلها أمور عارضة مضافة إلى إنسانية الإنسان وكينونيته وحقيقته. فلا يمكن أن تجعل من إنسان ذاتًا ومن إنسان آخر موضوعًا أو آخر فكلكم لآدم وآدم من تراب ﴿ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13).
إن من أخطر الأمور التي تجري عادة مجرى التداخل الثقافي فيغفل الكثيرون عن خطورتها هو هذا النوع من التداخل في المفاهيم بأن يؤخذ مفهوم نشأ في أحضان ثقافة معينة وفق رؤية كونية معينة، ونظرة إلى الحياة والإنسان مغايرة ليزرع ويستنبت كما تزرع الأجسام الغريبة في ثقافة أخرى. من هنا فإن المسلمين مطالبون أكثر من غيرهم والإسلام قد علمهم الدقة في اختيار المصطلحات وبناء المفاهيم وأمرهم بمراعاة ذلك في سائر الأحوال أن يكونوا في غاية الحذر حينما يستخدمون مثل هذه الأمور. والفكر الذي بني حول مفهوم الآخر في الفكر الغربي فكر له، وعليه. ولا شك أنه في بعضه إيجابيات معينة قد تمكن الاستفادة منها وتوظيفها، ولكن هناك فكر أيضًا نشأ حول هذا المفهوم وانطلاقًا منه لا يمكن للمنظور الثقافي الإسلامي ولا للنسق القياسي الإسلامي ولا للإطار المرجعي الإسلامي أن يتقبلها. فالآخر في نظر الديمقراطية الغربية التي ولد هذا المفهوم ونشأ وترعرع فيها لا بد أن يجري نوع من التعامل معه بأشكال ومستويات مختلفة بحسب الظروف فهذا الآخر أحيانًا يكون هدفًا للحرب أو القتال سواء أكانت حربًا وقائية أو حربًا استباقية فيفترض المحارب أنه إذا لم يسبق إلى مقاتلة هذا الآخر فإن هذا الآخر في أية لحظة يشعر فيها بالقوة والقدرة فإنه سوف يهاجمه وسوف يعتدي عليه ويفعل فيه ما يفعل، قام على ذلك نظام احتواء الآخر أيضًا بطرق مختلفة متشعبة. إذا لم تحتويه بالقوة فكيف تحتويه بالسلم فجاءت كل الأفكار الداعية إلى تغيير الثقافات وتغيير البرامج التعليمية في العالم منبثقة من فرضية الآخر، نحن والآخر We People & The Others فيفترض بهذا الآخر دائمًا من بل الذات أنه مصدر عداء أو مستودع للعداء يمكن أن يحرك ويوجه في أي وقت من الأوقات إذا لم تجر الهيمنة عليه وتحويل وجهته أو تفريغ ما فيه من شحنات. فطرح فكر التعددية وطرح فكر الديمقراطية والليبرالية وكل هذه المنظومات الفكرية طرحت وهي تحاول بناء الذات في مقابل الآخر. وتحاول أن تجيب عن سؤال كيف أجعل الذات باستمرار قوية متينة راسخة وكيف أجعل الآخر موضوعًا للاحتواء، للاستضعاف، لممارسة ما يجعل نحن المتفوق دائمًا عليهم وربما كان لذلك أثره في جعل طبيعة الحضارة العربية طبيعة صراعية تقوم على الصراع وتقوم على التوتر. بل تجد نفسها إذا انتفت عوامل الصراع وتوقفت عوامل التوتر في حالة ترهل أو في حالة استرخاء قد تهدد وجودها وتهدد كيانها كله. ولذلك فهي تحاول إذا لم تجد عوامل للتوتر وعوامل للتأزم التي تساعدها على أن تكون مشدودة على الدوام، مستعدة على الدوام للانتفاض على هذا الآخر الذي يتوقع منه باستمرار الأذى فإن ذلك يجعلها في حالة خطر.
من هنا فإن هذه الحضارة إن وجدت عدوًّا فبها ونعمت وذلك كما يقال عز الطلب. وإن لم تجد عدوًا فإنها تعمل على صناعته وتعمل على إيجاده كما تعمل على إيجاد المقويات أو الأركان والدعائم الذاتية لنفسها. فكلا الأمرين لا يمكن الفصل بينهما إذا أريد للحضارة أن تستمر وأن تزدهر وأن تستمر في فاعليتها وفي اندفاعها لا يوقفها شيء.
إذا استطعنا أن نفهم أن المنظومة الفكرية الغربية ومعها المنظومة النظومية كل ذلك إنما ينطلق من فكرة نحن والآخر أو الذات والموضوع. نكتشف أننا نحن المسلمين كل السلبيات التي دخلت مجتعاتنا قديمًا وحديثًا، وأوجدت عوامل صراع بيننا وربما أوجدت حتى التقاتل بدءاً من القتال الذي جرى بين الصحابة والفتن التي تلت ذلك وتفرق الأمة إنما نجم عن عامل آخر ليس هو ذلك العامل الذي يسمى بالآخر وإنما هو عامل آخر يلي ذلك العامل هو ما نص الباري سبحانه وتعالى عليه: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (آل عمران: 103)
وفي آية أخرى يقول الباري سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام:]لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[ (الأنفال: 63) فعملية التأليف بين القلوب خاصة بالنسبة للأمم المصطفاه المختارة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتؤدّي في حياة البشرية دورًا لا يمكن لغيرها أن تؤديه مثل بني إسرائيل قبل أن تنسخ آياتهم، ومثل الأمة المسلمة التي تمر بهذه الأحوال الرديئة السيئة من الفرقة والاختلاف والتشرذم والشتات.
هذه الأمم جعل الله سبحانه وتعالى لها مواصفات خاصة، فما يصلح لبقية الأمم من وسائل لا يصلح لها لكن ما يصلح لها هو ما حدده الله تبارك وتعالى نفسه باعتباره وسيلة تكوين، وسيلة بناء، وسيلة تقوية. أو عند الترهل وهذه الوسيلة هي وسيلة خاصة لا يمكن لها أن تتجاوزها بحال من الأحوال فإذا أصابتها الفرقة وأرادت التأليف بين القلوب فلن تستطيع أن تستخدم وسائل أخرى غير وسيلة الالتزام بحبل الله من جديد، وتكون الوسائل الأخرى من اقتصاد وما إليها وسائل داعمة معضدة ساندة وليست الوسيلة الأساس أما الوسيلة الأساس فلابد أن تكون الاعتصام بحبل الله تعالى: ]وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ[ (آل عمران: 103).
]لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[ (الأنفال: 63). من هنا فإذا أرادت الشعوب العربية وشعوب الأمة المسلمة أن تتجاوز مشكلات التمزق العرقي والطائفي والمذهبي والفصام بين الحكام والشعوب والتحزب والتحارب وتآمر بعضها على بعض، فإن الوسيلة الأساس لن تكون الوسائل التي اتبعتها أمم أخرى فنجحت معها أو فشلت أو حققت نسبة معينة من النجاح؛ ولكن الأسس والأصول التي بني عليها جرى تأسيس تلك الهوية، هوية هذه الأمة وهو الرجوع إلى حبل الله إلى كتاب الله والتمسك به وإعادة بناء الأمة من جديد لتكون أمة واحدة كما أرادها الله تبارك وتعالى تحمل سائر المواصفات والخصائص التي كانت أساسًا لبناءها وتكوينها وانطلاقتها.
بذلك يمكن أن نتغلب على عوامل الفرقة، على عوامل الاختلاف، على عوامل التنافر، نحن لا نعني بهذا أن نتجاهل عوامل مهمة كالاقتصاد والسياسة وما إليها ولكن الأساس والمحور الأساس إنما هو الاستمساك بحبل الله تعالى واجتماع الكلمة عليه ثم بعد ذلك تأتي الوسائل الأخرى من السياسة والاقتصاد والاجتماع وإلغاء الحواجز والحدود وما إلى ذلك، تأتي كلها باعتبارها عوامل ساندة، عوامل معضدة، عوامل يمكن أن تساعد في إعادة البناء.
من هنا فإن ما صدر إلى الساحة الإسلامية من اتهامات بأن ثقافة المسلمين بطبيعتها ثقافة توجد كراهية وتوجد تحقيرًا من شأن الآخر وتجعل من المسلم ذاتًا ومن غيره موضوع. هذه كلها إن صح إطلاقها على بعض جوانب الثقافة البشرية التي سادت بين المسلمين نتيجة عوامل انحرافهم وابتعادهم عن مصادر ثقافتهم الأصلية كتاب الله وسنة رسوله وسيرة رسوله عليه الصلاة والسلام وسير الأنبياء من قبله كل هذه الأمور إنما هي أمور طارئة. أمور لا تأتي من الإسلام ولم تفرزها ثقافة قائمة على أصول الإسلام ولكن أفرزتها ثقافات التراجع، ثقافات الانحراف، ثقافات الصراع، هي التي أوجدت كثيرًا من تلك الأمور وحين يقول الناس علينا بأن فقهاءكم يصنفون الأرض إلى دار حرب ودار إسلام، ويفسرون دار الحرب كما يشاءون وأنكم تقولون بأن هناك فسطاط لأهل الإيمان وفسطاط لأهل الكفر إلى غير ذلك من أمور وأن القرآن يصنف الناس إلى مشركين وكفار وأهل كتاب كفار، ويأمر بمقاتلتهم.
]قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[ (التوبة: 29).
هؤلاء حينما يأخذون هذه الآيات خارج إطارها وخارج سياقها وسباقها ويقطعونها عن بيئتها، فإن هؤلاء القوم يسيئون الفهم ويسيئون الإدراك، إدراك مرامي القرآن، وإدراك العلاقات بين هذه الآيات ويتجاهلون تاريخًا بأكمله، ويتجاهلون سبلاً ووسائل ومواقف لها شأنها لو أنهم اطلعوا عليها أو أخذوا هذه الأمور في إطارها وفي سياقها لما استطاعوا أن يذهبوا إلى ذلك الفهم المعوج والفهم الخاطئ البعيد عن روح الإسلام وروح القرآن وتوجيهه والبعيد عن سنة رسول الله r.
أما تصنيفات دار الحرب ودار الإسلام ودار العهد التي بدأها بعض فقهائنا وخاصة محمد بن الحسن الشيباني وغيره فهي تصنيفات كانت قائمة على واقع يعيشونه. فكان الناس في مواقفهم من الدولة الإسلامية يمكن تقسيمهم إلى تلك الأقسام. فهناك وحتى يومنا هذا بلدان تعتبر أمريكا أو دول المجموعة الأوروبية أو إسرائيل أو الدول العربية أن العلاقة بينها وبين تلك الدول يمكن تسميتها بعلاقة حرب أو معاهدة أو سلام أو ما يصنف ذلك. فالتصنيف الواقعي شيء والتصنيف المبني على الأصول شيء آخر ولذلك فرض كثير من علمائنا حتى في تلك العصور المبكرة عن هذه التسمية، واقترحوا أن تستبدل بدلاً من دار الحرب ودار الإسلام أن يقال دار الإجابة ودار الدعوة، دار الإجابة تطلق على ما سماه محمد بن الحسن وغيره بدار الإسلام باعتبار أن الله تبارك وتعالى قد قال: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ[ (الأنفال: 24).
وهؤلاء الذين استجابوا لله وللرسول تكون ديارهم ديار إجابة. والأمة منهم أمة إجابة وأولئك الذين أبوا ورفضوا تكون ديارهم ديار دعوة وليست ديار حرب. ذلك يعني أنها في حاجة إلى مزيد من الجهد لتعريفها بالإسلام ودعوتها إليه وبيان مزاياه لها فهي دار دعوة، فهناك دار إجابة وهناك دار دعوة وهناك أمة إجابة وهناك أمة دعوة؛ هذا التقسيم البديل تقسيم قد تبناه الإمام القسامي في القرن الرابع الهجري وتبناه بعده الإمام فخر الدين الرازي وآخرون كما نص الإمام على ذلك في التفسير. وبالتالي فالفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية فقه أمة واسعة مترامية الأطراف وحضارة عاشت قرونًا عديدة تداخلت مع حضارات العالم القديم وثقافاته، وأثرت في حضارات وثقافات العالم الجديد آثارًا لا يمكن إنكارها ولا يمكن تجاوزها فمحاولة أخذ بعض الجوانب بشكل انتقائي لمهاجمة هذه الأمة ولتصويرها بغير صورتها الحقيقية أو الأصلية أمر لا ينبغي لعادل مع نفسه أو منصف للبشرية أن يمارسه فإن في ذلك كثيرًا من الغش والكذب والمبالغة.
